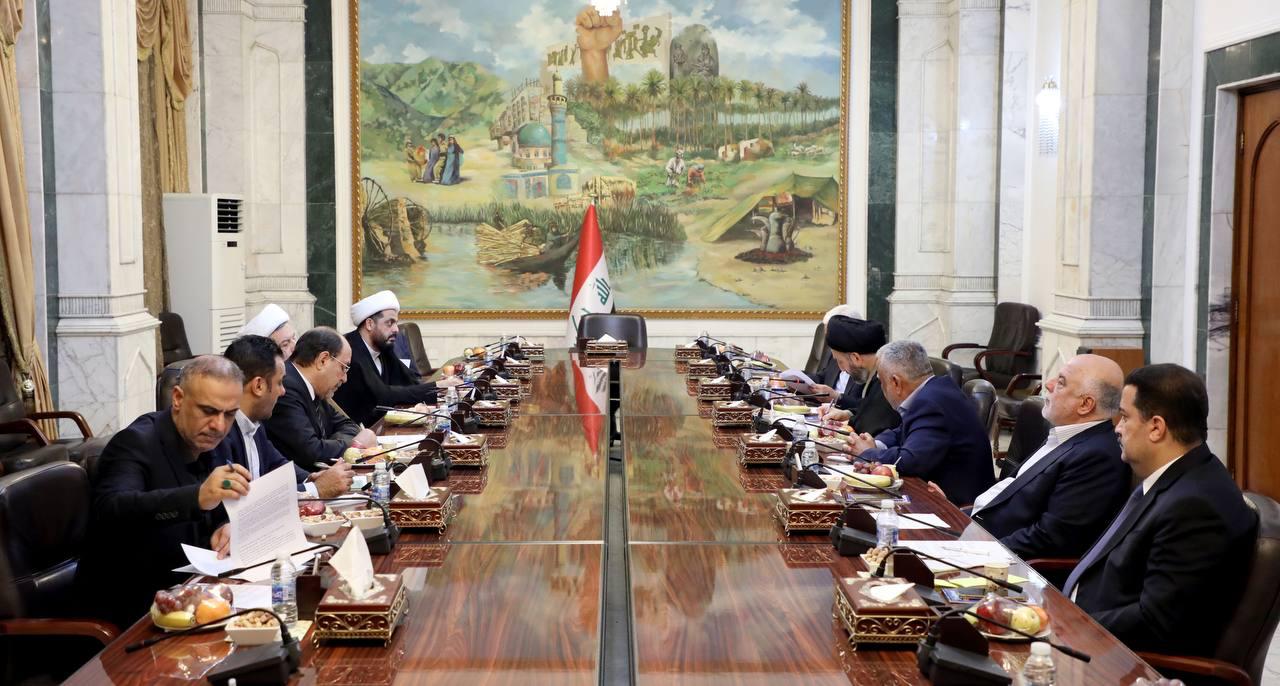حيـدر سعيـد*
نستغرق، دائمًا، في مناقشة الحدود التي تفصل بين “الثورة”، و”الانتفاضة”، و”الوثبة”، و”الهبّة”، وما إلى ذلك من كلمات تحاول توصيف حركات اجتماعية كبرى، منها الحراك القائم في العراق منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 2019.
وإذا كانت هذه المفاهيم لم تُصنَع داخل مختبرات أكاديمية، بل بدأت في الخطاب السياسي أولًا، فإنها خضعت إلى جهد أكاديمي ونظري مكثّف، لتمييز كل منها، وضبط حدود دقيقة فاصلة بينها. ومع ذلك، لم نستطع يومًا الوصول إلى رسم حدود قاسية بين هذه المفاهيم، لا على مستوى الخطاب السياسي، ولا على المستوى الأكاديمي والنظري، الذي ظلت فيه هذه الحدودُ حدودًا مختبرية، تحاول تصنيف الحركات الاجتماعية، التي تشهد – على الأرض – تداخلًا وسيولة كبيرين بينها، فضلًا عن تنوع أشكالها على نحو ثرّ.

وُضعت هذه المفاهيم في تراتبية، فأعلاها هو الأكثر جذرية في إحداث قطيعة في البنية السياسية و/ أو الاجتماعية القائمة. وأتحدث، هنا، عن مفهوم “الثورة”، الذي – بسبب من هذا – بدا مفهومًا جذّابًا وَذَا شحنة انفعالية، فبدأ يُستعمَل في خطابات سياسية، تمجيدًا لحركات اجتماعية بعينها. وقد شهدنا في العقود الماضية سجالات كبيرة على حركات ولحظات قطع سياسي مهمة في تاريخنا، هل هي “ثورات” أم لا، كالسجال على “ثورتي” 1952 و1958 في مصر والعراق، أو حتى بعض السجال على الربيع العربي. ودائمًا، كان الدفاعُ عن توصيف هذه الأحداث بأنها “ثورات” دفاعًا تمجيديًا، منتميًا لها أو لما أفرزته وفتحته من معانٍ، وكان يبدو التشكيك في كونها “ثورات” مُغرِضًا.
ولذلك، ومع ادعاء الأطر الأكاديمية والنظرية لهذه المفاهيم وحدودها، كان جزء غير قليل من النقاش نقاشًا غير أكاديمي، بل نقاش مسيّس، ورغبوي، وغير محايد. و، دعني أقل، كان الاستعمالُ السياسي الأول لهذه المفاهيم، الذي أكسبها شحنة قيمية انفعالية، يتنقّل داخلَ المختبرات الأكاديمية، وهي تحاول التنظير لها.
غير أن ما أحاوله، هنا، في طرح سؤال “الثورة” وصفتِها على الاحتجاجات العراقية الراهنة ليس نقاشًا أكاديميًا، ولا أريد ذلك، وليس محاولة تمجيدية، مع أن عواطفي – أعترف – ليست محايدة تجاه الاحتجاجات، فليست هذه الكلمات – في النهاية – سوى خطوط يرسمها مَن يبصر ظلالَه هناك، ولكنه يفتقدها، في الساحات التي تصدح فيها مطالبُ العدالة والكرامة.
ما أسعى إليه، من خلال محاولة فهم الاحتجاجات الراهنة بوضعها في إطار التصنيفات القائمة، هو محاولة لفهم ماهيتها، وقد يكون فهمها لنفسها. وأنا أدرك أن السرديات التي تُنتَج (ونُنتجها، بل ينبغي أن ننتجها) عن الحركة الاحتجاجية لن تكون مفصولة عنها، حيث تختلط اللغة والخطاب بالوقائع، وتكون جزءًا منها، وتُنتجها، وترسم صورتَها، تمامًا، كما الشعارات والهتافات.
انهمكتُ، كثيرًا، بمتابعة الحركات الاحتجاجية في العراق ما بعد الغزو الأميركيللبلاد وسقوط نظام صدام حسين في عام 2003، والتي تصاعدت منذ عام 2009، متخذة وتيرة محددة: أنها تظاهرات مطلبية، يحرّكها تردي الخدمات وقصور الدولة وأجهزتها عن الوفاء بالتزاماتها في هذا المجال. وقد كان آخر هذه الاحتجاجات انتفاضة البصرة في صيف 2018. أستثني من هذا الحكم حركةَ الاحتجاج التي انطلقت في شباط/ فبراير 2011، بتأثير مباشر من الربيع العربي، وتزعمها مثقفون وناشطون يساريون، وكانت المطالَب الديمقراطية فيها واضحة، وحركةَ الاحتجاج في المحافظات السُنّية (2012-2013)، التي كانت ذاتَ طابع هوياتي.
كنت أفترض، دائمًا، أن هذه الاحتجاجات المطلبية جزء من الظاهرة الريعية وثقافتها الدولتية، أي الإيمان بأن الدولة هي الناظم الأول والأخير للمجتمع. ومن ثم، كانت الاحتجاجاتُ، بمعنى ما، مطالَبة بالدولة، إلى الحد الذي نستطيع أن نتحدث فيه عن معادلة (أظن أنه يمكن تعميمها لفهم سائر الحركات الاحتجاجية في البلدان الريعية): أنه كلما ضعفت الدولة، نشطت الحركة الاحتجاجية، وكلما قويت الدولة واستطاعت الوفاء بالتزاماتها، ضعفت الحركة الاحتجاجية وخمدت.
وهذا التحليلُ (والفهم) يصدق على الحركة الاحتجاجية الراهنة في مبتدئها: أنها ابتدأت في إطار مطلبي، ينتظر جوابًا من الدولة.
غير أن هذه الحركة، في ديناميكتها وتطورها، ما بين مطلع تشرين الأول/ أكتوبروخواتيمه، شهدت تفاعلات وتطورات كبيرة، جعلت منها نقطةَ تحول نوعي في سياق الحركات الاحتجاجية ما بعد 2003، فالاحتجاجُ (الذي بدأ مطلبيَ الطابع) تحول إلى “ثورة”.
حين أكتب هذا السطر، يهمّني أن أستدرك بأنني لم تحركني عواطفي المنحازة للحركة الاحتجاجية، ولسائر الحركات الاحتجاجية، وهو موقف لا معنى لـ “المثقف” من دونه، بل إنني أكتب بمعرفتي (غير المكتملة، بالتأكيد) بالأطر النظرية لمعنى “الثورة”.
لماذا ثورة؟
لأن الحركة الاحتجاجية، حتى وإن بدأت على يد فئات اجتماعية محددة، فإنها انفتحت لتُشرك فيها سائرَ فئات المجتمع.
ولأنها خرجت من المطالَب المباشرة، لينبني – بالتدريج – إيمان بأن هذا النظام، بوضعه هذا، غير قادر على الوفاء بالمطالب، وغير قابل للإصلاح، ومن ثم، ينبغي تغيير النظام، وإعادة صياغته بشكل جذري، لينبني نظام بديل، قادر على استيعاب المطالَب.
قد تكون هذه الفكرة (أن هذا النظام غير قابل للإصلاح) موجودة من قبل، هنا أو هناك، غير أن المهم الآن أنها أصبحت عامة، فبدأ يشترك في الثورة كل من يحس بعيوب النظام، أوسعَ بكثير من المطالَب المباشرة التي انطلقت منها الحركةُ الاحتجاجية، فالذين نهش الفسادُ كرامتَهم، والذين أجبرتهم الدولةُ على البقاء تحت نير شظفٍ لا يعرف أيَّ معنى للإنسانية، والذين قيل لهم: اقبلوا بالفتات، فالعمر رحلة قصيرة وتنقضي، والذين وأدت سيطرةُ أحزاب السلطة كفاءاتهم لصالح منتسبيها، والذين أُذلّوا بسبب استهتار الطبقة السياسية بالمال العام، والذين نُكّل بفرصهم وطموحاتهم في الحياة تحت شعارات إيديولوجية ترفعها الأحزابُ المسيطرة، والذين افتقدوا الأمنَ تحت حراب السلاح المنفلت، والذين سفحت أهواءُ الخارج وإملاءاتُه كرامةَ وطنهم، هؤلاء كلُّهم بدأوا يحسّون أن الثورة تجسيد لهم.
وهكذا، تخلّق “فضاء ثوري” (جسّدته ساحةُ التحرير في بغداد، برمزيتها العالية)، تصب فيه كل فئات المجتمع، الموجودة داخله أو خارجه، إسهاماتها في الثورة، دعمًا، وعواطف، ومطالب، وتصورات، وآمالًا، ورهانات، فضاء ثوري تتكثف فيه رؤية تغيير النظام، نحو نظام أكثر عدالة.
ما الثورة، إذن، إن لم تكن تحركًا جماهيريًّا عامًا، تحركه رؤية بتغيير النظام، وإقامة نظام بديل، يلبي طموحاتها ومطالبها وتوقها نحو العدالة؟
وأكثر من ذلك، أظن أن الصورة التي أرسمها، هنا، لا عهد سابقًا للعراق بها، وكأن العراق الذي انتفض مرات ومرات، على احتلال أجنبي، أو سلطات ظالمة، لم يعرف معنى اجتماع فئات مجتمعه كلّها، على مطلب تغيير النظام، وتحركها على وفق هذه الرؤية، إلا الآن.
هل أقول إن ثورة تشرين الأول/ أكتوبر 2019 هي الثورة الأولى التي يشهدها العراق الذي عرفناه؟
أكاد، نعم.
*أكاديمي وباحث عراقي